لم تكن مجرد رحلة، بل كانت استجابة لنداء داخلي، لأسئلة ملحة ظلت ترن في ذهن الصحفي والمؤلف هشام آيت الموح لسنوات.
في أكتوبر 2017، قرر هشام، الذي اعتاد استكشاف دروب المغرب على دراجته الهوائية، أن يواجه فضوله الكبير تجاه الجزائر، تلك الجارة القريبة-البعيدة التي تفصلها عن وطنه حدود برية مغلقة بسبب قرار سياسي جزائري.
كيف تبدو الحياة هناك؟ ما أوجه الشبه والاختلاف خلف ذلك الحاجز السياسي؟ لم يكن هناك سبيل للعبور المباشر، فكان الحل يمر شرقاً، عبر تونس.
حمل هشام دراجته، رفيقة دربه، وانطلق نحو تونس، البوابة الضرورية لتحقيق حلمه بدخول الجزائر براً. ومن هناك، حجز تذكرة عودته، ليس براً، بل جواً من الجزائر، تاركاً مسألة الدخول نفسها للمستقبل وقرار الجيران.!
كانت مغامرة محفوفة بالشك، فكم من مغربي قبله أُعيد على أعقابه. لكن القدر كان رحيماً، وانفتح أمامه معبر “بوشبكة” الحدودي في الجنوب التونسي، ليبدأ فصلاً جديداً ومثيراً في رحلته التي استمرت قرابة الشهر في استكشاف البلدين.

استراحة في تبسة
كانت تونس محطته الأولى، حيث قضى وقتاً مستكشفاً طرقاتها ومدنها وقراها، من ضواحي العاصمة إلى عمق تاريخها. زار “تكرونة” الشاهدة على الحرب العالمية، وتأمل عظمة “المهدية” الفاطمية، وشعر بعبق الفينيقيين في “قرقنة” والإباضيين في “جربة”. صعد جبالها الأمازيغية حيث يسكن البعض الكهوف، وعبر صحراء “شط الجريد”. في كل خطوة، كان يلمس التشابه مع المغرب ويستمتع بخصوصية تونس، بينما يختمر في داخله سؤال الدخول إلى الجزائر.
ثم جاءت لحظة العبور المنتظرة. الدخول إلى الجزائر براً من بوشبكة كان بحد ذاته تجربة فريدة، بداية من منطقة مختلفة عن الساحل المباشر.
بمجرد أن استقرت عجلتا دراجته على التراب الجزائري، شعر وكأنه كسر حاجزاً رمزياً. انطلق هشام في رحلته الجزائرية، متجهاً شمالاً نحو الساحل. مرّ بمدن تاريخية عريقة مثل قسنطينة المعلقة، وجيجل الساحلية، وعبر منطقة القبائل بجمالها الطبيعي وثقافتها المميزة متوقفا بمدينة تيزي وزو، واقترب من العاصمة الصاخبة.
كان يندهش لتشابه أسماء الأماكن، الناظور، الدار البيضاء، وغيرها، التي رددت صدى أسماء يعرفها في وطنه. شعر بعمق التاريخ المشترك وهو يتنقل بين مواقع شهدت أحداث الفتوحات الإسلامية أو حرب التحرير التي لم يكن المغرب غائباً عن دعمها.

رفيقة درب هشام في وقفة جانبية على احدى الطرق التونسية
لم تخلُ الرحلة من تحديات، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. التخييم لم يكن سهلاً كما في المغرب، لكن كرم الضيافة الجزائري كان استثنائياً يحكي هشام للمحيط.
بمجرد أن علم الناس بوجوده ورحلته، انهالت عليه الدعوات. “مرحباً بك، أجي عندنا” كانت لازمة الترحيب التي فتحت له أبواب البيوت والقلوب، ليقضي ليالي عديدة ضيفا على عائلات جزائرية، يشاركهم طعامهم وحواراتهم، ويلمس بنفسه دفء العلاقات الإنسانية التي تتجاوز تعقيدات السياسة.
لاحظ هشام أيضاً بصمات الاستعمار الفرنسي الطويلة (130 عاما) التي شكلت ملامح الشمال الجزائري بطريقة مختلفة عن المغرب. أدرك بعمق كيف أن البلدان الثلاثة، المغرب والجزائر وتونس، تتشابه في جوهرها كثقافة شمال إفريقية، لكن لكل منها طابعها الخاص وروحها المتفردة.
واصل هشام رحلته على دراجته غرباً على طول الساحل، مقترباً أكثر فأكثر من الحدود المغربية، ليس ليعبرها، بل ليصل إلى آخر نقطة ممكنة في مساره الجزائري، إلى منطقة “واد كيس” أو “بين لجراف” قرب مرسى بن مهيدي. هناك، عند ذلك الوادي الذي يرسم حداً جغرافياً وسياسياً، وقف ليتأمل المشهد الفريد والمؤلم لأهالي الضفتين، جزائريين ومغاربة، يتبادلون التحايا والإشارات عن بعد، عابرين الحدود بأرواحهم ونظراتهم فقط.

في طريقه إلى تيزي وزو إحدى أهم مدن القبائل
لم يعبر هشام الوادي، فقد كانت مهمته الاستكشافية من الجانب الجزائري قد أوشكت على الانتهاء، لكنه شعر بعمق أثر هذا الإغلاق على حياة الناس وعلى الروح المغاربية.
انتهت رحلة الدراجة الهوائية داخل الجزائر. ومن هناك، توجه هشام إلى المطار ليصعد على متن الطائرة عائداً إلى المغرب، حاملاً معه ليس فقط ذكريات وصور، بل فهماً أعمق، وتجربة إنسانية غنية، وشهادة حية دوّنها في كتابه “وا ديتمودون، المسافر” الذي صدر مؤخرا.

لقد كانت رحلته دليلا على أن الفضول والشغف الإنساني قادران على إيجاد الطرق حتى وإن بدت الدروب السياسية موصدة، وأن الروابط بين الشعوب تبقى أقوى من أي حدود.

اعتاد هشام التقاط أنفاسه خلال الرحلة، ومعها صورة عابرة لتحنيط اللحظة
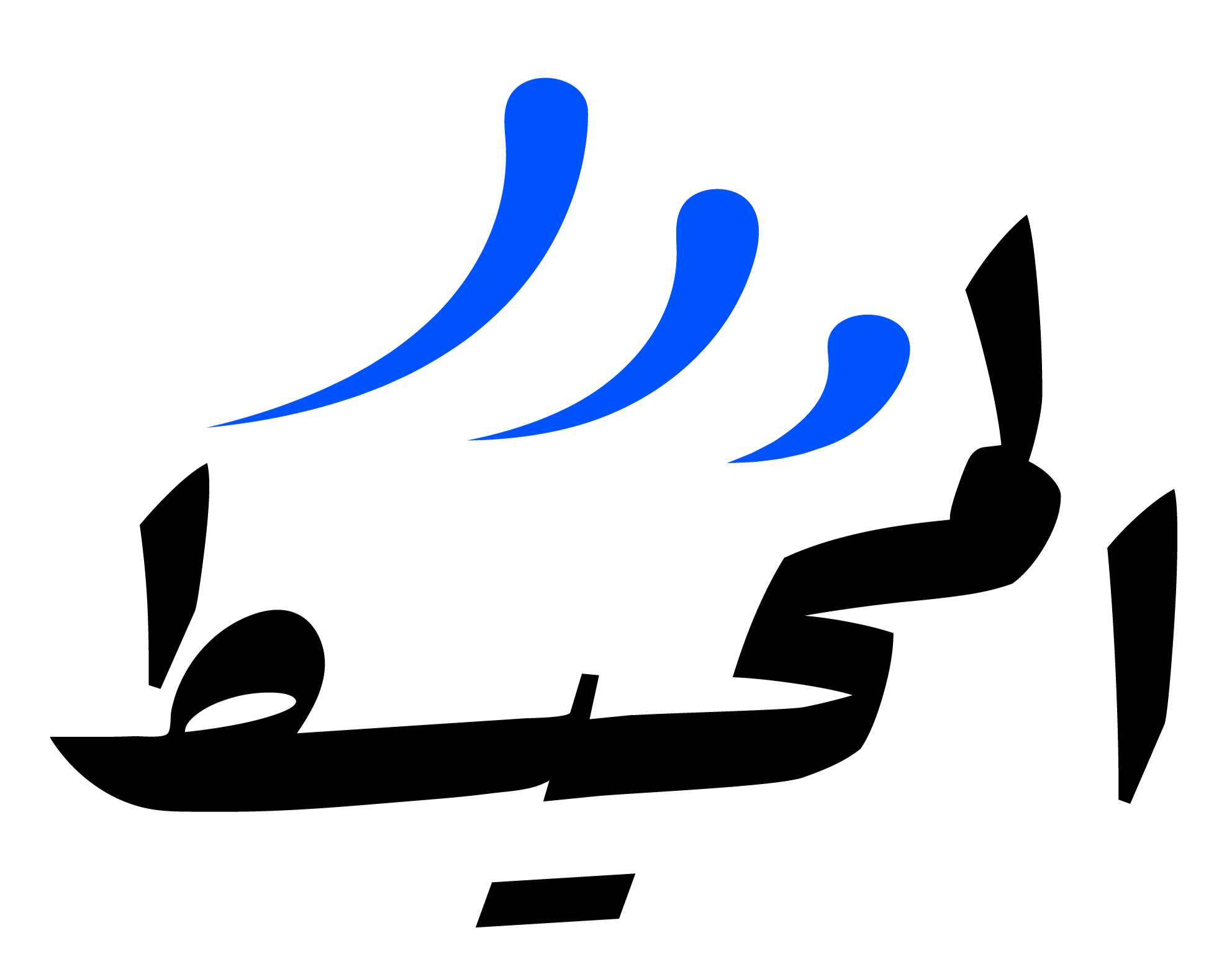








1 تعليق
قصة ملهمة فعلا ، نتمنى ان تعود الجزائر الى رشدها وتفتح الحدود المغلقة بين البلدين